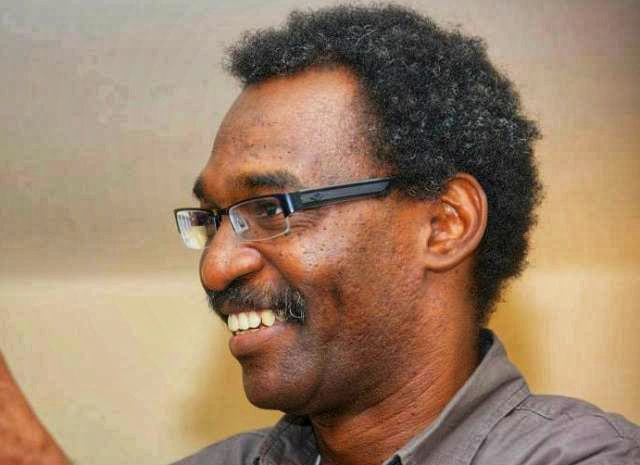كثيرون يدركون أن الدرجات العلمية العليا تُمنح أساسا لتطوير المباحث الأكاديمية. وذلك يعني أنها ترقية في عرصات العلم المعني بما يكفل تثوير العلوم على الدوام.
ولكن المبادرين بإنشاء الدرجات العلمية هذي، أبدا، لم يكن هدفهم أن يصير اللقب منحة للامتياز الاجتماعي في ساحات السياسة، أو الدين، أو الرياضة، أو الفن.
ويدرك هذا تماما من حازوا على الشهادات العليا. وفي العالم الثالث، حيث لا تتوطن شفافية للنخب، نشأت ثقافة أساسها أن الحاصلين على الألقاب المتقدمة سواء في مجال الكيمياء، أو طب الحشرات، أو غسل الجنازة، أو التجميل، ينبغي أن ينالوا أيضا امتيازا في المجال العام بمثل الذي حازوا عليه في مدارج العلم.
وللأسف فإن معظم هؤلاء الذين حصلوا على هذه الدرجات العلمية توقفوا عن تقديم المباحث بعد نيل هذه الدرجات، وكأنما أن الهدف لم يكن أصلا مواصلة البحث الحر في المجال المحدد، أو التدريس في الجامعة حتى تستفيد الأجيال من قدراتهم، ويكون لدرجتهم العلمية معناها الحقيقي.
والأنكى وأمر أن هناك فئة عاشت في الغرب ولم تحز على شهادة الدكتوراه ولكنها تصر على أن يكون اسمها أكثر التصاقا بالدال.
وتراهم عائدين إلى البلاد ليقوموا بخداع الحكومات لتوظيفهم. وهناك فئة في الداخل حازت في ظل غياب الشفافية على درجة الدكتوراه دون أدنى مجهود، وبعض أركانها التحق بالتدريس وترقى إلى درجة عميد.
ربما كان هؤلاء النفر من الناس قد قرروا أصلا اللحاق بقطار زملائهم الذين استفادوا من اللقب مجتمعيا، خصوصا وأن ثقافة النخبة التي وطنتها لا تختلف عن سياسة مجتمع بعض البقارة.
فكلما امتلكت الآلاف من الأبقار كان حظك عظيما في مجلس الرأي السديد والتداول الحكيم في فضاء برلمان الفريق.
والحقيقة المرة أن عدد العلماء السودانيين الذين حصلوا على هذه الشهادات العليا ممن تتسنى لهم الكتابة في الدوريات العالمية لا يتعدى أصابع اليد.
بل إن عددا مهولا مما نسميهم الخبراء، والمستشارين، في أدق تفاصيل حياتنا العامة لم يسبق لبعضهم أن نشر بحثا ذي قيمة في الدوريات الإقليمية حتى.
أما الذين ينمون البحث عبر الدوريات السودانية فإن مشكلتهم كبيرة، إذ إن جامعاتنا لا تحفل بنشر أبحاثها التي لها علاقة لها بالواقع المعاش.
وهاهنا تبدو هذه الجامعات، خلافا لما نشاهده في دور العلم في العالم المتقدم، معزولة عن سياسة المجتمع، واقتصاد المجتمع، وثقافة المجتمع، وسوق المجتمع، وعمران المجتمع، وفن المجتمع.
وأذكر أن الفنان زيدان المعروف بسخريته وصف مرة معهد الموسيقى والمسرح بشارع الدكاترة، منتقدا الذين لم ينتجوا في مجال الموسيقى، والغناء، والبحث.
ورغم الكلمة الجارحة من الفنان الراحل إلا أنه أراد تنبيهنا إلى هذا العدد المهول من الحاصلين على درجة الدكتوراه في الموسيقى الغناء والمسرح.
وقصد أن يقول لهم إن عبرة الخلود الفني ليست بالدال، وإنما بالإنتاج، وتقديم البحث الكثيف عن ما لا نعرفه عن أسرار موسيقانا وغنائنا.
ولكن ما لا يعرفه زيدان أن النشر الجامعي آخر اهتمامات من يضعون الميزانيات. فأفضل الذين عرفوا في مجال الاهتمام بمجال النشر الثقافي هو زهير حسن بابكر، الحاصل على درجة الأستاذية في مجال الآثار.
ولكن أحالوه للصالح العام رغم أنه كان من أميز من قدموا تجربة فريدة في النشر الأكاديمي، والثقافي، وأقام معارض المليون كتاب التي جلبت الملايين من الدولارات للجامعة. وكان يرافق المعارض بفاعليات ثقافية سنوية ضمت أبرز رموز الأدب في العالم العربي، ولذلك شاهدنا هناك أدونيس، ومحمود درويش، ومظفر النوب، وهم يقدمون أمسيات قيمة في السودان.
وقد علمت لاحقا أن زهيرا كافأته بلاده بالاعتقال لسنوات بعد أن أسس دار الخرطوم للنشر، وتعرض لأسوأ محنة جعلته بعيدا عن الجامعة، والمجتمع، ومجال النشر الذي أبدع فيه.
والآن يعاني زهير وزملاؤه في هذا المناخ بينما يصبح السلفيون المتطرفون الذين درسوا في جامعة أم القرى عمداء في جامعة الخرطوم.