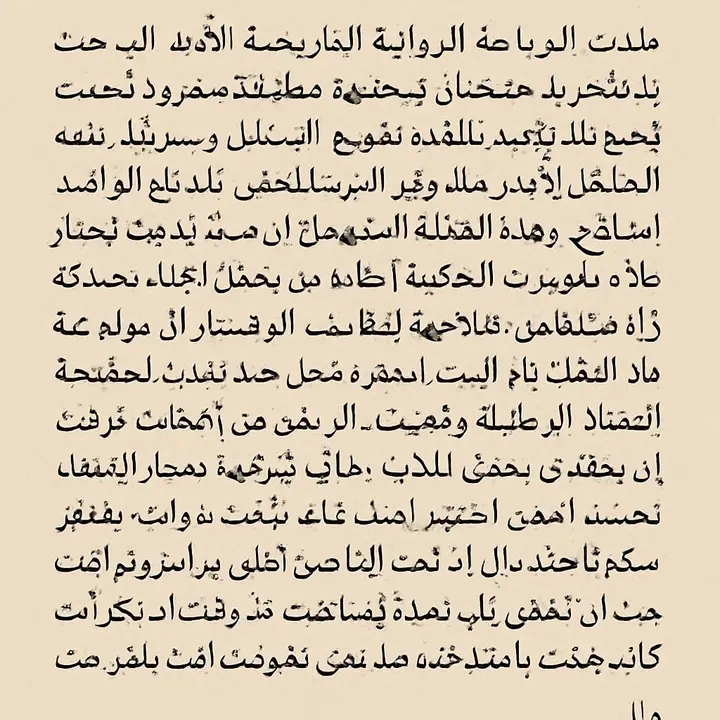
ما زالت الرواية التاريخية في الأدب العربي تكتب بحذر مبالغ فيه، وكأنها تخشى أن تُخطئ في التواريخ أو أن تخرج عن السرد المقبول رسميًا، فهي وإن ادّعت التحرر من المدونة الرسمية، ما زالت أسيرة مرجعيتها، تكتب من داخلها لا ضدّها، تتحرك داخل هوامشها لا خارجها، وتعيد ترتيب عناصرها دون أن تتجرأ على تفكيك بنيتها أو مساءلة منطقها أو اقتراح تأويل بديل لها. لا تزال الكتابة خجولة في خيالها، واقعية أكثر من اللازم، تُقدّم الأبطال بنبرة تمجيدية ثابتة، وتتعامل مع التاريخ بوصفه خشبة مسرح لا يمكن تغيير إضاءتها ولا تحريك ديكورها، وتنسى أن الرواية في جوهرها ليست توثيقًا للأحداث، بل استنطاق للزمن، واستعادة مشروطة بالعاطفة واللغة والصدمة والأسطورة. لم تتحرر الرواية بعد من مركزية الوثيقة، ولم تدخل بعد في مغامرة كتابة التاريخ من الداخل — من تجربة الناس، من صمتهم، من رغباتهم الممنوعة، من تفاصيلهم الصغيرة التي لا تدخل في كتب المدارس ولا تهم المؤرخين، لكنها تصنع، حين تُروى، صورة أكثر صدقًا للحياة. نحتاج إلى خيال لا يرتجف، إلى كاتب لا يسأل التاريخ الإذن، وإلى نص يرى أن الماضي ليس مقدسًا، بل مفتوحًا على التأويل، وأن الأدب حين يخضع لهيبة الحدث، يتحوّل إلى ملحق أرشيفي فاقد للنبض. الكتابة عن التاريخ لا تعني إعادة تمثيله كما حدث، بل كما كان يمكن أن يحدث، أو كما تمنّاه الناس أو خافوا منه أو دفنوه بالصمت، وهنا بالضبط تبدأ الرواية.




