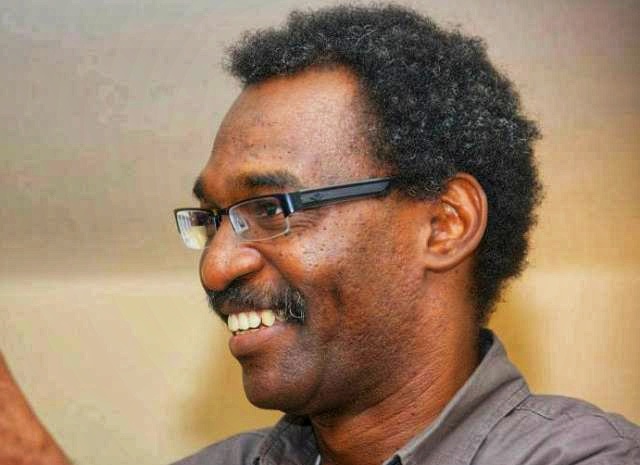
هكذا تتفرع ذيول أزمة النقد لننتهي إلى تكرار القول إنها معقدة جدا جدا بالنظر لظروف بلادنا.
ومن خلال التجربة في الإشراف على الملاحق الثقافية قبل عقدين من الزمان كنا نعاني الأمرين. فعمل الملاحق الثقافية أقرب للجهد الصحفي الذي تتكامل مع صحافات سياسية، واقتصادية، وفنية، ورياضية، تلك التي ينتجها محررو الصحيفة، أو المجلة.
فالمساحات التي تتاح للملاحق الثقافية وقتذاك لا تتجاوز صفحتين أسبوعيتين.
فالملف الثقافي معني بكل مناشط المشهد الثقافي، وليس الأدب فحسب. لا بد من إبراز مساحة لتغطية فاعلية ثقافية، وتناول أخبار الساحة المحلية، والإقليمية، والعالمية، ونشر قصة، وقصيدة، وإدارة حوار مع فنان تشكيلي، أو مسرحي، وتقديم قراءة لكتاب جديد، وهكذا دواليك.
وهذا العمل لا تستوعبه الصفحتين، وبالتالي يُصعب تضمين مادة نقدية لرواية، أو ظاهرة ثقافية، أو لوحات لسلفادور دالي مكتشفة حديثا.
والأنكى وأمر أن رئيس التحرير حين تضايقه كثرة الإعلان لا يجد حلا سوى التضحية بصفحة ثقافية.
وأحيانا تغادر الصحيفة فرحا أنك سلمت سكرتارية التحرير صفحتين ثقافيتين، ولكنك عند الصباح تفاجأ أن واحدة قد سحبت. بل أحيانا تسحب الصفحتين معا، ولا تقدمان في اليوم الذي يليه، وإنما بعد أسبوعين حتى دون تقديم اعتذار للقارئ المهتم الذي ينتظر الملف الثقافي بلهفة.
وبطبيعة الحال فإن نشر مادة لناقد لا تقابل بمكافأة، ولذلك نادرا ما تجد نقدا راتبا في الملاحق الثقافية، والتي هي أصلا مادة صحفية لا يوجد من يستطيع سحبها جميعا دون النشر أكثر من رئيس التحرير، وهو الذي لا يفرق بين محمد حسنين هيكل وبين محمد حسين هيكل.
أما الآن برغم انفتاح الفضاء للمادة الثقافية بصورة لا تقارن مع الماضي فإن المساحات كبيرة للنقد، والنقاد، شأنهم شأن بقية المنتجين الثقافويين.
سوى أن الأزمة ما فتئت تتفاقم. فمع زيادة المادة الثقافية شح النقد، وقل النقاد إلا محاولات قليلة لا تفي بالحاجة.
وشاهدنا أن عددا من المبدعين ظلوا يعوضون هذا الضمور لدور الناقد من خلال البحث عن الصيت الإعلامي في الفضائيات، ووسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم التي تضم الأهل، والأصدقاء، والمعجبين.
وهؤلاء يسهمون في تشجيع المبدعين جميعا، بما فيهم من مؤلفين، ومغنين، ومسرحيين، وتشكيليين، ولكن ما ينقصهم هو معرفة خصائص العمل الفني.
فاعتمادهم على عاطفتهم نحو المبدع المجود، وغير المجود لعمله، لا يغني عن أهمية دور الناقد، وحاجة المبدع إليه، واعتماده على ذاكرته العقلانية، لا العاطفية.
والسؤال هو كيف يمكن معالجة هذه الأزمة، خصوصا أن غياب النقد المفترض فيه التقويم، يعني غياب المعيارية في الحكم على هذا النشاط الأدبي الكثيف الذي تضخه ماكينات النشر، وتحتويه منابر الإنترنت؟ فضلا عن هذا فإن تلاشي النقد يضر بالساحة الثقافية، إذ يختلط الإبداع الضعيف بالثمين. بل تضيع محاولات إبداعية متقدمة، وتتاح الفرصة لأخرى ضعيفة بفعل التحشيد العاطفي الذي لا يجيده بعض المبدعين.



