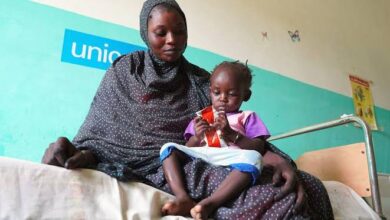في ظل التحولات العنيفة التي يشهدها السودان، بات الحديث عن تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة أمراً يكتنفه كثير من التعقيد. إذ لا يمكن مقاربة هذا الهدف في السياق الراهن دون النظر إلى الخلفية السياسية والاجتماعية التي أوصلت البلاد إلى لحظة الانفجار الشامل في صبيحة الخامس عشر من أبريل، فهذه الحرب، بما صاحبها من عنف دموي وانقسام حاد في البنية المجتمعية السودانية، ليست حدثاً معزولاً، بل امتداداً طبيعياً لمسار طويل من التمزيق المنهجي الذي قادته الحركة الإسلامية منذ استيلائها على السلطة في يونيو 1989، وأعملت كل أدواتها السياسية “الميكافيلية” في تخليقه واستمراره.
بالنظر إلى عقود حكمها، سعت الحركة الإسلامية عبر ذراعها السياسي – حزب المؤتمر الوطني – إلى إعادة تشكيل الدولة السودانية وفقاً لرؤية إقصائية، عمدت فيها إلى تفكيك المنظومتين العسكرية والمدنية السياسية، وزرع الشكوك والانقسامات في نسيج المجتمع السوداني، وقد تم ذلك من خلال سياسات محسوبة استندت إلى مبدأ “فرّق تسد”، ليس فقط كأداة لبسط النفوذ، وإنما كأساس لضمان البقاء في السلطة وسط مشهد متشظٍ، يخلو من الإجماع الوطني، ويفتقر إلى الحكمة السياسية.
منذ انفجار حرب أبريل، بدا جلياً أن هذه الحرب ليست سوى امتداد عضوي لهذا المشروع السياسي – الأمني، فالمعطيات تشير بوضوح إلى أن الحركة الإسلامية لعبت دوراً محورياً في إشعال فتيل الحرب، بهدف قطع الطريق على أي انتقال مدني عبر الاتفاق الإطاري، الذي كانت القوى المدنية تسعى لاستكماله. فخلال شهر رمضان من عام 2023، نشطت اللقاءات والاجتماعات داخل دوائر الحركة الإسلامية، في سياق تعبئة سياسية وأيديولوجية للحرب، ما يعكس إصرار الحركة على العودة إلى السلطة عبر الفوضى والانقسام، والتشرذم، وإغراق المشهد السياسي بعدم الأمن، والانحدار نحو تفكك المجتمع دينياً.
ومن المفارقات اللافتة في هذا السياق، أن قوات الدعم السريع، التي تشكل الطرف الآخر في هذا النزاع الدموي، لم تكن بعيدة عن العباءة ذاتها، أي هي وليدة الحركة الإسلامية، فهي نشأت أصلاً برعاية وتخطيط من ذات النظام، الذي وفر لها دعماً مالياً وعسكرياً واسعاً، ليس بهدف بناء قوة عسكرية وطنية، بل في إطار لعبة توازنات داخلية هدفت إلى تحجيم المؤسسة العسكرية الوطنية، وإضعافها كخطوة استباقية لمنع أي انقلاب محتمل على السلطة الإسلامية، وفي هذا الإطار نجد أن صفوة الحركة الإسلامية امتلك كل واحد من صقورها مليشيات مسلحة، تصرف ميزانيتها من خزينة الدولة، وتؤدي إلى تحقيق أغراضه السياسية، وحفظ توازنه في جسم التنظيم الإسلامي.
هذا الواقع أفرز واقعاً معقداً للمواطن السوداني فوجد نفسه أمام خيارين قسريين: الجيش النظامي الذي يعيد تصدير نفسه كحامي للدولة، أو قوات الدعم السريع التي باتت رمزاً للفوضى والانفلات والقتل والتشريد، غير أن هذه الثنائية تخفي حقيقة أكثر خطورة، وهي أن الحرب الحالية، بصرف النظر عن أطرافها، هي بالأساس نتاج ترتيبات سابقة هدفت إلى إعادة إنتاج ذات المشروع السلطوي، وإن بوجوه جديدة. ويتجلى هذا الهدف كل يوم مع تقدم هذه الحرب، وتتزايد المؤشرات على تفكك الدولة، وتنامي ظاهرة المليشيات القبلية والمناطقية، حيث أفرزت الحرب عشرات المليشيات القبلية المسلحة، ما ينذر بمزيد من التدهور، وربما الانزلاق نحو حروب أهلية مصغرة، وإذا لم تبادر القوى المدنية، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي، إلى بلورة مشروع وطني جامع، فإن فرص إنقاذ السودان من خطر التفكك ستنعدم في ظل تنامي النعرة القبلية.
ما تجدر الإشارة إليه أن قراءة المشهد السوداني لا تكتمل أركانها دون إدراك الترابط بين الماضي والحاضر، بين المشروع الإسلامي الذي عمل على تقويض مؤسسات الدولة، والحرب الحالية التي تُعد امتداداً لهذا المشروع، والسؤال الأبرز لم يعد ما إذا كانت الحرب ستنتهي، بل كيف يمكن تحويل نهايتها إلى فرصة حقيقية لبناء دولة المواطنة، لا إعادة تدوير سلطوية مُدمّرة، وهو تحدٍ سيواجه الحركة الإسلامية قبل أن يكون تحدياً للقوى المدنية المغلوب على أمرها، حيث ستجد الحركة الإسلامية نفسها عاجزة عن تدارك الفوضى التي صنعتها بالحرب، وحينئذ فلن تحكم إلا مِخيال دولة.