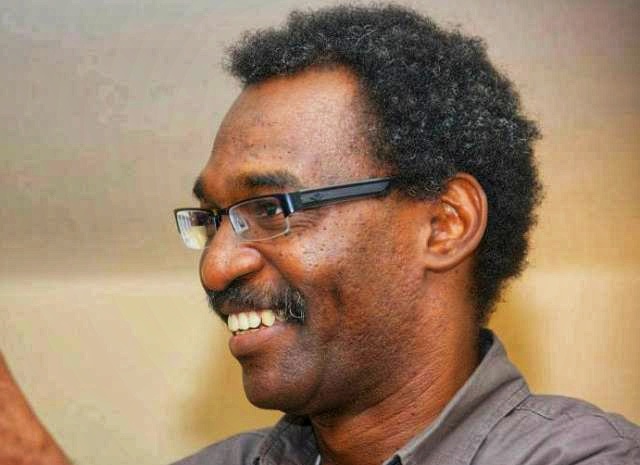
السودان الثقافي مدهش، ولكن قليلين يدركونه بحق.
وبدلا أن يفهم من خلال مواريثه الفنية الغنية، والمتعددة، نستعين قسرا بالعرب، والأفارقة تارة، والأصولية الأممية بجانب السلفية المسلمة، تارة أخرى، لفهمه.
وأحيانا نصب قوالب المناهج الأوروبية صبا تجريديا لنخطط لشعوب البلاد التي حافظت على وجودها آلاف السنين.
وإيقاعات السودان الموسيقية جزء من المدخل لفهم تاريخ شعوبه القديمة، والوافدة، التي انصهرت، وخلقت هذا المكون الاجتماعي في الريف ثم المدن.
وإيقاعات السودان الموسيقية مقبولة في إيما بيئة وجدت تجمعا سكانيا.
فحين وظف عمر الشاعر إيقاع قبيلة الفور الأساسي – الفرنقبيا – في أغنية “أسير حسنك يا غالي” خلق اختراقا في إيقاعات زيدان إبراهيم، والذي أصلا يتحدر من غرب السودان، ولكن نسبة لنشأته في أمدرمان نحا منحى المجددين للأغنية القومية.
وفرنقبية الفور الثرية التي أجادتها الفنانة مريم أمو همشت في عرض الإعلام المركزي، وظلت ترن فقط في شعاب الجبل، وسهول زالنجي. وإن كان قد تسنى لتومات كوستي اختراق نغم الستينات بما سمي إيقاع التمتم الذي هو أساسا إيقاع قبيلة الداجو واسمه “الجكتك”، كما اكتشف الباحث إبراهيم سوناتا، فإن الفرنقبيا ما تزال بحاجة إلى كونها مجالا للاستعارة الفنية في النغم.
وكذا الأمر ينطبق على إيقاعات الجراري، والهسيس، والتويا، وجمل رقد، والكمبلا، والبالمبو، وغيرها.
وذلك المسعى أفيد في تجديد الاغنية السودانية لاستيعاب أنغام وإيقاعات الأطراف، والتي بسبب هيمنة إيقاعات بعينها في مخيال المؤلفين الموسيقيين لم تجد حظها من التجريب.
كل هذه التوظيفات النغمية، والإيقاعية، المتفردة في البيئة السودانية تدلنا على مزاج السوداني، وحيوية، وثراء قدرته على التأقلم مع البيئة بقدر كبير من التسامح الإنساني.
ولذلك يصعب تكييف هذا المزاج وفق مناهج لا تتناسب مع بيئة للتساكن فريدة.
ولأن الإيقاع في حد ذاته نغم – من خلال ضرباته المتعددة التي تخلق موازير فنية – بدا يؤدي في ريف السودان دورا أساسيا لتنويع الرقص.
ولو تميزت قبائل السودان باستخدام كل الجسد في الرقص فإن ما ميز قبيلة الحمر التي تملأ فراغ كردفان الشمالية استخدام الرقبة، والصدر، في طقوس الأعراس التعبيرية.
ومن هنا تبدو أهمية فهم جميع النخب لهذا الموروثات الفنية السودانية، كونها تتصل بجذور هوية السودانيين وتاريخهم، وأحاسيسهم، وأمزجتهم، وغيرها من لوازم شخصياتهم المتنوعة.



