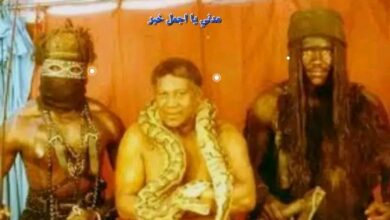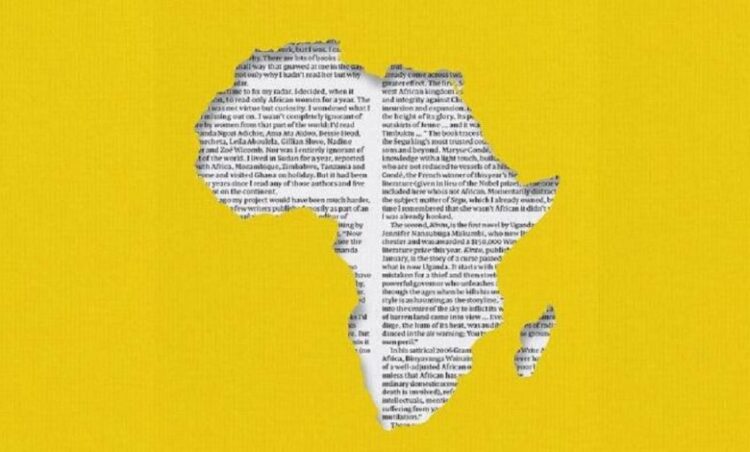
إن كثيرًا من الناس لا يُفرّقون بين أهمية دور مؤلّف العمل الأدبي والمترجِم، أو على الأقل يخلطون بينهما بالرغم من أنهما ليسا مختلفين بالمرة بل متكاملين.
قراءة في كتاب “فخّ خداع الذات: المساعدات الخيرية كآلية اقتصادية لإدامة التبعية في العلاقات الإفريقية–الأوروبية”
إن المؤلف صاحب الفكرة كالزارع صاحب البذرة الذي يضعها في أرض الفن، ويرويها بالإبداع حتى تؤتي ثمارها نورًا وتنويرًا، وهو من خلال عمله الأدبي يُعبِّر عن خبرة شخصية أو مجتمعية في ظروف ما وذات خصائص تَحُدّها حدود مرجعيته اللغوية والثقافية، بل حتى الروحانية.
وهنا يأتي دور المترجم الذي يتولَّى تحرير العمل الأدبي من قَيْد المحدود إلى اللامحدود.
إنّ المترجم لا يقوم بمجرد عملية نقل اللفظ من لغة إلى أخرى، وإلا كانت عملية استنساخ ضحلة وبلا قيمة، بل إنه عندما ينقلها من لغةٍ لأخرى فإنه يبعث فيها روحًا جديدة، ويضخّ في عروقها دماء جديدة عن طريق ترجمة دلالة الكلمات سواء في سياقاتها المشتركة ما بين لغة وثقافة المؤلف الأصلي، ودلالاتها المشابهة لها لغويًّا وثقافيًّا في اللغة المقابلة والمُترجَم إليها العمل.
إن عملية الترجمة يلتزم فيها المُترجِم من خلالها بنقل مكونات الثقافة المُترجَم منها العمل الفني إلى ما يتوافق مع مكونات الثقافة الخاصة بلغة المُترجِم، مع الالتزام بمنهج عدم الإخلال بالفكرة أو الصور الجمالية التي يُوظِّفها المؤلف الأصلي والالتزام بترجمة الدلالة اللفظية والمعنوية للألفاظ والتراكيب والمصطلحات في حالة عدم وجود نظير مباشر لها، وعدم تجاهل القواعد النحوية وكيفية توظيفها تركيبيًّا ضمن النصوص.
إن المترجم يُعيد بَعْث الروح في جسد العمل الأدبي، ويجعله أكثر انفتاحًا وانتشارًا وقدرة على النفاذ إلى آفاق أكبر وأوسع تشمل مجتمعات متنوعة وعرقيات مختلفة ليحقق بذلك الانتشار والشهرة للمؤلف.
وحتى ندرك أهمية دور المترجم علينا أن نطرح سؤالًا: لماذا يحتاج الأديب دائمًا إلى المترجم؟
الإجابة هي أنه إذا أراد الأديب أن يُحقّق المزيد من الشهرة الشخصية والانتشار لأعماله والتوعية بأفكاره، فإنه من غير الممكن أن يحقق ذلك باستخدامه لغة واحدة فقط في كتابة أعماله وتسجيل إبداعاته وإنتاجه الأدبي، وإلا فإنها ستصبح محدودة وقاصرة على هؤلاء الذين يملكون معطيات لغة العمل الأصلية، أو على الأقل يكونوا مُلِمّين بالجوانب الثقافية للكاتب. وهنا يأتي دور المترجم الذي هو في الواقع ذو أهمية كبيرة بل وحيوية في انتشار ونشر المعرفة والخبرات الإنسانية بين المجتمعات المختلفة، ونقلها بما فيها، مضافًا إليها من جيلٍ إلى جيلٍ ليتشكل بذلك تراث حضاريّ إنساني متجدّد على مرّ الزمان مهما اختلف المكان أو الناس.
لقد سطر الأدب الإفريقي نفسه في كتاب الزمان بحروف من نور، وفي ارتباطه بالمكان كان كطود عظيم يضرب بقواعده في الأرض. لطالما كان الأدب الإفريقي معينًا تَنْهَل منه شعوب القارة فيروي ظمأ أنفسهم، وكان كطائر يُحلِّق بجناحيه في سماء الحرية، وأرضًا كانت وما زالت تنبت وتزهر قِيَمًا وتقاليد فريدة من نوعها، وبحرًا يستخرج من أعماقه لآلئ الخبرة والتراث اليافع الثري، ورحمًا خرجت منه ثقافات أَثْرَت الدنيا وتاريخها.
إن الأدب الإفريقي كان سلاحًا لمبدعيه، وكان دائمًا مُسدَّدًا إلى قلب الظلم والقهر، وسيفًا بتّارًا أشهروه في وَجْه الكبت والغرور والعدوانية التي اتَّسم بها المستعمرون وغاصبو أراضيها. لقد كان شمعة في أيدي مُبْدِعيه شقّوا بنورها قلب ظلام التخلُّف والجهل وعمليات التجهيل الممنهج وتشويه الحضارات الإفريقية وشعوبها ليكونوا دائمًا عبيدًا عند الاستعمار وخدمًا تحت أقدام مصالحهم.
إن هناك أزمة كبيرة تعاني منها المكتبة العربية، خاصةً في مصر، تتمثل في ضعف ونُدرة ترجمة الأعمال الأدبية الإفريقية بأنواعها المختلفة إلى اللغة العربية. إن هذا الأمر غير مقبول؛ إذ كيف يُعْقَل أن تكون مصر جزءًا لا يتجزأ من إفريقيا وحضارتها مكانًا وزمانًا، وفي نفس الوقت هناك جهالة شديدة بمعطيات الثقافات الإفريقية الأخرى وآدابها ومفكريها؟ كيف يمكن أن يتحقّق التواصل والتكامل المجتمعي والسياسي والاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، ونحن لا نعرف شيئًا عن مجتمعاتها وتاريخها؟
إن اللوم لا يقع على المواطن المصري تحديدًا أو بالنسبة للعرب عمومًا، بل يقع على كاهل الباحثين والمترجمين الذين لا يُؤدّون أدوارهم، ولا يدركون قَدْر الالتزامات التي تقع على عاتقهم في إطار منهجية التطوير الثقافي والانفتاح الفكري الذي يُؤدّي بدَوْره إلى قدرة أكبر على سبر أعماق المجهول من روائع الأدب الإفريقي الذي يُسهِّل ويُيسِّر من عمليات التواصل والاتصال مع أصحاب هذه الشعوب، وبالتالي فإن هذا سيُشجّعهم أن يقوموا بعمل دراسات وترجمات للإبداعات العربية محققة بذلك انتشارًا غير محدود في مجتمعات تجهل الكثير عن الثقافة العربية، مما يُرسي قواعد الثقافة العربية بشكل أكبر ضمن هذه المجتمعات تمامًا، كما كانت ومازالت تفعل دول الغرب الاستعمارية.
المشكلة الأخرى هي أن المترجم العربي إن وجد العمل الأدبي الإفريقي فإنه ما يزال يعمل في ظل محددات المصلحة الشخصية البحتة، وأهمها هي كم سيربح من وراء هذه الترجمة. كما يسأل نفسه ما فائدة أن أترجم عملًا أو أعمالًا لهذا الأديب أو المفكّر أو ذاك، وهو ليس من الأسماء المعروفة لدى القراء؟ وهل يستحق الأدب الإفريقي هذا الجهد والعناء، وليس هناك مَن يقرأه أو قراء يعرفونه؟ كل هذه التساؤلات بالإضافة إلى تقاعس وتخاذل الحكومات ودور النشر هي بحق أسباب تجمعت للنيل من شخصية الأدب الإفريقي وتجفيف منابعه.
إن الحل يأتي ضمن محورين؛ الأول: مرتبط بمدى جاهزية المترجم لغويًّا وثقافيًّا وعلميًّا للتعامل مع معطيات العمل الأدبي الإفريقي. وفي سبيل تحقيق ذلك، على المترجمين المُؤهَّلين أن يخرجوا أولًا من شرنقات الكسل والتقاعس، وأن يُحرّروا أنفسهم من بين صدفات التفكير في إطار الربح المالي الضخم؛ فلو أنهم عملوا على ذلك لفتحوا مجالًا جديدًا غير مطروق كما يجب أن يكون عليه، وأصبحت لديهم القدرة على اجتذاب فئات أكبر من القراء، وبالتالي ولادة تخصُّص جديد في الدراسات الأدبية والإبداعات الإفريقية التي تمتاز بروعتها وبساطتها وكونها لا تستخف في موضوعاتها بالقِيَم والتقاليد، وسيترتب على ذلك كله تحقيق مكاسب كبرى ومتجددة كلما زاد الطلب عليها.
أما المحور الثاني، فيقوم على دعم الحكومات والهيئات والمنظمات ودور النشر لمترجمي الأدب والإبداع الإفريقي مما سيحثهم بطريقة أكثر إيجابية للإقبال على هذه الترجمات.
* أستاذ الأدب واللغات الإفريقية – باحث ومتخصص في الأدب الإفريقي.