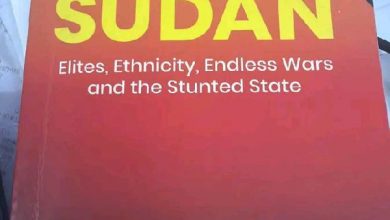لكلِّ مدينةٍ ذاكرةٌ لا تُحفَظها الكتبُ وحدها، ذكرياتٌ تمشي بين الناس وتتنفَّس معهم. روحٌ تتجسَّد في أصواتها؛ أصواتٌ لا تُسمَع فحسب، بل تُعاش، تُلامس الوجدان، وتفتح، كلَّما ذُكِرَت، نوافذَ الحنين على مُدرَّجاتٍ ازدحمت بالهتاف، وميكروفوناتٍ قالت ما هو أبعدُ من إعلانٍ، وما هو أصدقُ من خبرٍ عابر.
وحين يُستدعى اسمُ ود مدني، يتقدَّم إلى الواجهة صوتٌ لا ينعزل عن صورتها، ولا ينفصل صداه عن ذاكرتها؛ صوتُ مدثَّر يوسف، الذي أحبَّه الناس ونادوه بلقبه الأثير “القطر”. لم يكن مدثَّر هو المذيعَ الداخليَّ لاستاد المدينة وحسب، بل كان نبضَها الخفيّ، وذاكرتَها السمعيَّة الحيَّة، وسجلَّها الشفهيَّ الذي حفظ أفراحها وانكساراتها، ورافق بطولاتها الصغيرةَ والكبيرة، جيلًا بعد جيل.
في القسم الأوَّل البدايات
وُلِد مدثَّر يوسف في حيِّ القسم الأوَّل العريق، ذلك الحيّ الذي كانت الحياةُ فيه تُصنع بالأيدي، وتُدار بالعلاقات، ويُحفظ فيه الجارُ جارَه كما يحفظ اسمَه. هناك، في تفاصيل العمل اليوميّ، والعرق، والتكافل، تشكَّلت شخصيَّته الأُولى.
نشأ في أسرةٍ لها صِلةٌ بالرياضة، فتسرَّبت كرةُ القدم إلى دمه مبكِّرًا، لا كلعبةٍ فقط، بل كطَقسٍ اجتماعيّ. وكان لوالده، قارئِ القرآن الكريم، أثرٌ بالغٌ في تكوينه؛ إذ أورثه حبَّ الكلمة، والانتباهَ للنُّطق، واحترامَ مخارج الحروف، وهو ما سيصبح لاحقًا جوهرَ صوته، وأساسَ قدرتِه الفريدة على التحكُّم في النبرة والإيقاع.
عمل في بداياته نجَّارًا بالقسم الهندسيّ في مصلحة الكهرباء، مهنةٌ تتطلَّب الصبرَ والدقَّة، لكنَّ قلبَه كان مُعلَّقًا بالمايكروفون. كانت الكلمةُ تناديه، والصوتُ يُلحُّ عليه. فبدأ تسجيلَ المباريات المدرسيَّة، والفعاليَّات السياسيَّة، خطوةً خطوة، حتى صار صوته مألوفًا في بيوت ود مدني، حتى قبل أن تعترف به الإذاعة.
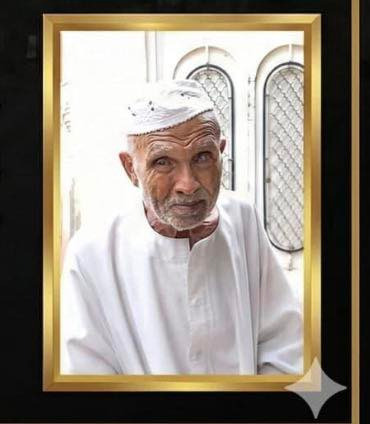
الإذاعة الرسميَّة: الرَّجفة الأُولى
دخل القطرُ الإذاعةَ الرسميَّة في ود مدني بدعمٍ من روَّادها أُسامة علي حسين وصلاح طه. وكانت أُولى مبارياته الرسميَّة تلك التي جمعت الهلالَ والأهلي. لحظةٌ لا تُنسى؛ مزيجٌ من الخوف، والرهبة، والرَّجفة التي تسبق الاعتراف. لكنَّ شغفَه بالرياضة، وإيمانَه بصوته، كانا أقوى من التردُّد. استعان بتجاربه السابقة في تسجيل مباريات المدارس، وصقل أسلوبَه، وحوَّل كلَّ ثانيةٍ إلى حدث، وكلَّ جملةٍ إلى دعوةٍ للانتباه. لم يكن يُعلِّق فقط، بل يصنع مشهدًا صوتيًّا كاملًا.
“دولةٌ صوتيَّة” داخل الاستاد
حين ضاقت بإمكاناته فرصُ الإذاعة الرسميَّة، لم يغادر الملعب ولم يستمر مذيعًا رسميًا لفترة طويلة.. غادرالإذاعة وصنع مساحتَه الخاصَّة. أسَّس دولتَه الصوتيَّة داخل استاد ود مدني.
بسيَّارة صديقه هاشم الخليفة، كان يجوب السوقَ وأحياءَ المدينة نهارًا، مُعلنًا عن المباريات الكبرى. لم يكن الإعلانُ مجرَّدَ معلومة، بل احتفالًا مُسبقًا، ودعوةً جماعيَّة، ووعدًا بالإثارة. صوتُه الجهوريّ كان يسبق المباراة، ويُهيِّئ الجمهور، ويحوِّل اللقاءَ إلى مناسبةٍ عامَّة.
صاغ عباراتٍ خالدة، ومنح الفِرَق ألقابًا صارت جزءًا من الذاكرة الشعبيَّة: “اتحادُنا يا باسم، يا فرحَ كلِّ المواسم”، “أهلينا أرجنتينا”، “الأهلي عقيدةٌ وأحلى قصيدة”. لم تكن هذه الترنيماتُ شعاراتٍ عابرة، بل علاماتٍ سمعيَّة محفورة في وجدان المدينة.
إنسانُ الملعب
في الاستاد كان هو الملكَ المتوَّج. يصول ويجول مع الكرة، ومن أجمل لحظاته، تلك الفقرةُ بين الشوطين، حين يُعلن تكريمَ الشخصيَّات الرياضيَّة من أبناء مدني. كان صوته آنذاك صوتَ امتنان، يُعيد الاعتبارَ للجهد وللرجال، ويُؤكِّد أنَّ الرياضةَ أخلاقٌ قبل أن تكون نتائج.
ورغم عشقه الذي لم يخفَ لنادي النيل مدني، ظلَّ القطرُ منحازًا للإنصاف، داعمًا لكلِّ الفِرَق، جاعلًا الاستادَ مساحةً للوحدة، لا للتعصُّب.
كان القطرُ أكثرَ من صوت؛ كان روحًا حاضرة. يروي النكات، ويُخفِّف التوتُّر، ويمنح اللاعبين ألقابًا تليق بهم، ويحوِّل الأسماءَ إلى حكايات. معه، لم تكن المباراةُ مجرَّدَ زمنٍ يُلعَب، بل ذكرى تُعاش.