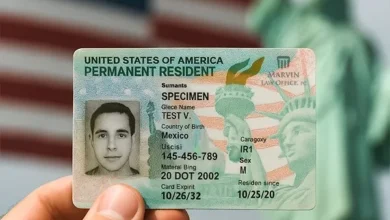مناورة إثيوبيا في البحر الأحمر.. لماذا تبقى أرض الصومال الخيار الأمثل؟
ترجمة: د. عمر عبد الفتاح

تتمتع فكرة تسخير إمكانات النيل الأزرق والتحكُّم فيه لتوليد الطاقة الكهرومائية بتاريخ طويل في إثيوبيا، إلا أن التكنولوجيا والموارد المالية لم تكن متوافرة آنذاك لتحقيق مثل هذا المشروع الطموح. ويعود التصور الحديث لسد النهضة الإثيوبي الكبير إلى سلسلة من الدراسات والمفاوضات التي امتدت على مدى عقود.
ففي أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، على سبيل المثال، أجرى مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي دراسة شاملة للمنطقة، وأوصى ببناء عدة سدود متتالية على طول النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهرومائية. إلا أن نقص التمويل أوقف تنفيذ تلك المشاريع. ومع ذلك، فإن أحد المواقع المقترحة، والذي يُسمى “السد الحدودي”، يتوافق مع الموقع الحالي لسد النهضة الإثيوبي الكبير.
وللأسف، طغى الجدل الدائر حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير على التطلعات التاريخية لإدارة المياه بشكل تعاوني بين إثيوبيا ومصر والسودان في حوض النيل الشرقي. ومن بين محاولات التعاون التي تكللت بالنجاح اتفاقية الإطار التعاوني، التي تُرسي مبادئ الاستخدام العادل والمستدام للمياه بين بعض دول حوض النيل الأخرى.
وقد دخلت هذه الاتفاقية الإطارية حيّز التنفيذ رسميًّا في أكتوبر 2024م، بعد سنوات من المفاوضات. وقد وُضعت هذه الاتفاقية مِن قِبل مبادرة حوض النيل، وهي شراكة حكومية دولية بين دول حوض النيل. وسوف يُؤسّس هذا التطور التاريخي لجنة دائمة لحوض نهر النيل لتنسيق إدارة المياه العابرة للحدود، إلا أن مصر والسودان لم توقِّعا على هذه الاتفاقية بعد.
وفي حين أن سدّ النهضة الإثيوبي الكبير سيعمل كسد كهرومائي غير مستهلك للمياه؛ حيث يخزن ويطلق المياه مؤقتًا أثناء توليد الطاقة، إلا أن مصر والسودان تشعران بالقلق من أن هذا المشروع الضخم قد يُهدِّد أمنهما المائي. ونتيجةً لذلك، ورغم أن إثيوبيا ومصر والسودان درست مشاريع مشتركة مختلفة لاستخدام مياه النيل، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل، مما دفَع الحكومة الإثيوبية إلى بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير بشكل منفرد.
تحسينات في السد متعددة الوظائف
وبالإضافة إلى وظيفة السد الأساسية في توليد الطاقة، يخدم سد النهضة الإثيوبي الكبير أغراضًا حيوية متعددة؛ ومنها القدرة على السيطرة على الفيضانات؛ حيث سيساعد السد على تنظيم تدفق مياه النيل الأزرق، مما سيُخفّف من آثار الفيضانات المدمرة في دول المصب، وخاصةً على السودان.
ومن المتوقع أن تزيد قدرات السد المُحسَّنة في إدارة المياه من الإنتاجية الزراعية من خلال الري، مما يعود بالنفع على المنطقة أيضًا. ومن الناحية الاقتصادية، يُتيح سدّ النهضة الإثيوبي الكبير فرصةً مهمةً لإثيوبيا لزيادة عائداتها من العملات الأجنبية من خلال تصدير فائض الطاقة، مما يُعزز النمو الاقتصادي العام لديها.
وربما الأهم من ذلك، ومن منظور وطني إثيوبي، فإن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُمثِّل رمزًا للفخر الإثيوبي والاعتماد على الذات، مُظهرًا قدرة البلاد على تنفيذ وتمويل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق بشكل مستقل. الأمر الذي مثّل تحولًا كبيرًا من اعتماد إثيوبيا على المساعدات الخارجية إلى التنمية الذاتية.
مزاعم تواصل فصيل من جبهة تحرير شعب تيجراي مع إريتريا فوضى إستراتيجية أم جنوح لليأس؟
منذ منتصف عام 2024م، ظهرت تقارير عديدة تزعم عقد سلسلة من الاجتماعات بين بعض الشخصيات السياسية والعسكرية من إقليم تيجراي الإثيوبي وممثلين عن الحكومة الإريترية. وقد نفت جبهة تحرير شعب تيجراي هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، مؤكدةً أنه لا الحزب ولا جيش تيجراي أجريا أية “اتصالات سرية مع الحكومة الإريترية”. ولعله في محاولة لاغتنام الفرص التي أتاحتها هذه المزاعم، اتهم وزير خارجية إثيوبيا إريتريا الأسبوع الماضي بالتعاون مع “فصيل من جبهة تحرير شعب تيجراي” من أجل شنّ هجمات منسَّقة بين الفريقين.
وبالنظر إلى شدة هذه الادعاءات، يتساءل تسيجازيب كاهسو، كاتب هذا المقال قائلًا: لماذا إذن ينخرط فصيل من جبهة تحرير شعب تيجراي -وهي حركة تشكلت خلال الحرب، وترسخت عبر عقود من التنافس الأيديولوجي وعبر إراقة الدماء في ساحات المعارك ضد إريتريا-، مع النظام نفسه الذي ارتكب فظائع لا توصف ضد شعب تيجراي؟”، ويؤكد الكاتب أن الإجابة لا تكمن في إعادة تنظيم إستراتيجي شامل أو أيّ براجماتية جديدة، بل تكمن في الإرهاق السياسي والتشرذم الداخلي والوجودية المؤسسية في تيجراي.
ويوضح الكاتب أنه بعد توقيع اتفاقية بريتوريا للسلام في عام 2022م، التي أنهت الحرب رسميًّا، تحوَّلت جبهة تحرير شعب تيجراي -“التي كانت مهيمنة في السابق على الهيكل الفيدرالي لإثيوبيا”- إلى “فاعل إقليمي يعاني من فقدان الشرعية ومن الاستياء الشعبي وكذلك من التفكك الداخلي”. ويشير تسيجازيب إلى أن هذا الفراغ من حيث الهدف ومن حيث التماسك الداخلي أدَّى إلى “انحراف إستراتيجي”.
ويواصل تسيجازيب حديثه ويقول: وفي خضم هذا الانجراف فإن بعض فصائل جبهة تحرير شعب تيجراي تنظر حاليًا إلى إريتريا في عهد “إسياس أفورقي” ليس من خلال عدسة التاريخ، بل باعتبارها رافعة تكتيكية محتملة؛ أي باعتبارها ثقلًا موازنًا للضغط المتزايد من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، أو من الفصائل التيجرانية المتنافسة، أو حتى من الاضطرابات الشعبية.
ويحذر المقال من أن اللجوء إلى إريتريا في عهد “إسياس أفورقي” لتحقيق ميزة تكتيكية هو بمثابة “مقامرة متهورة”، مؤكدًا أن “هذا نظام انتهازي يزدهر في الفوضى والانقسام بين جيرانه. ويحذر الكاتب من أن الرئيس “إسياس أفورقي” لا يسعى إلى التحالفات؛ بل يُهندس التبعيات، مؤكدًا أن الاعتقاد بأن مثل هذا النظام يمكن أن يكون حليفًا موثوقًا به لتيجراي الجريحة والمنقسمة ليس مجرد سذاجة سياسية، بل هو بمثابة انتحار.
مناورة إثيوبيا في البحر الأحمر..لماذا تبقى أرض الصومال الخيار الأمثل؟
وقَّعت إثيوبيا في يناير 2024م مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، بهدف تمهيد الطريق لتحقيق طموح إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر. وقد أثارت مذكرة التفاهم هذه في حينها موجة فورية من ردود الفعل الدبلوماسية السلبية في منطقة القرن الإفريقي وخارجها. ويناقش زريهون هايلو، كاتب هذا المقال، بأن أرض الصومال لا تزال “المسار الأكثر جدوى للمضي قدمًا”، مؤكدًا أنها “مستقرة نسبيًّا، وتخضع لحكم مؤسسات ديمقراطية، وتُظهر دعمًا شعبيًّا لتوثيق العلاقات مع إثيوبيا”.
وفي ظل وجود ما يزيد عن 120 مليون نسمة من سكان إثيوبيا، ونظرًا لافتقارها إلى وجهة بحرية ساحلية، يؤكد زريهون أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر “ليس ترفًا بل هو ضرورة”، ويقول: إن ذلك أمر “أساسي لحماية مصالحها الوطنية”.
ويؤكد الكاتب أن أرض الصومال “تبدو أكثر موثوقية من دولة الصومال؛ حيث لا تزال مناطق واسعة في الصومال تقع تحت سيطرة حركة الشباب”. كما يشير الكاتب كذلك إلى أن جيبوتي، الشريك البحري التقليدي لإثيوبيا، تتبنَّى الآن “موقفًا أكثر تشددًا”، بعد رفضها طلبات إثيوبيا بالحصول على حق الوصول إلى الموانئ الخاصة، في حين تتحالف بشكل أوثق مع مصر وإريتريا. وهذا التحول، إلى جانب موقف إريتريا “المحفوف بالمخاطر” و”المتزايد في المواجهة” تجاه إثيوبيا، يعزز موقف أرض الصومال. ويضيف الكاتب أن المجتمع الدولي -بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة-، يُظهر “اهتمامًا دوليًّا متزايدًا” بميناء بربرة في أرض الصومال، إدراكًا لأهميته الإستراتيجية لأمن البحر الأحمر.
وكذلك أكد زريهون أن المشهد الإقليمي يتغيَّر بسرعة كبيرة، قائلاً: “ما كان يُنظَر إليه في البداية على أنه سوء تقدير استفزازي –أي: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال-، قد يُنظَر إليه الآن على أنه إعادة تقييم ذات رؤية”.
ويخلص الكاتب إلى أنه “مع تبنّي جيبوتي لخط قومي أكثر صرامة، وميل الصومال نحو منافسي إثيوبيا الإقليميين، وتزايد ميل إريتريا إلى المواجهة، فإن أرض الصومال تقدم لإثيوبيا المسار الأقل مواجهة والأكثر بناءً إلى البحر الأحمر”.
أشباح صامتة وجنون العظمة الصاخب.. ما الذي يطارد قيادة إقليم صومالي الإثيوبي؟
يذكر محمود أحمد، كاتب هذا المقال، أن حزب الازدهار الحاكم (PP) في إثيوبيا لا يقف اليوم كائتلاف عشوائي، بل كتحالف منظّم قائم على التوافق والرؤية المشتركة. ويشير إلى أن من بين صفوفه هناك شخصيتان بارزتان هما: آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار، وأحمد شايد، وزير المالية، وكلاهما من الإقليم الصومالي.
ويقول: إن كلا المسؤولين يشتركان في اعتقاد راسخ مفاده أن: “حزب الازدهار الحاكم ليس منبرًا للصراخ، بل هو سفينة للتجديف معًا”. وفي المقابل، يرى الكاتب أن رئيس الإقليم الصومالي في إثيوبيا، السيد مصطفى محمد عمر، “يبدو متورطًا في مفارقة سياسية، أو في دوامة أزمات ذاتية الصنع”، مضيفًا أنه “حيث يرى الآخرون مساحة للنمو، يرى هو ظلالًا من التخريب”. ويشير الكاتب إلى أن قيادة مصطفى عمر لطالما خيَّمت عليها “مزاعم القمع، وكبت حرية التعبير، والفساد” التي تنسب إليه.
ويتساءل الكاتب عن سبب صمت شخصيات مثل آدم فرح وأحمد شايد، قائلاً: “هناك تصوُّر متزايد بأن كلا الرجلين، على الرغم من جذورهما الإقليمية ومنصبهما الفيدرالي الرفيع، قد اختارا التمويه المؤسسي بدلاً من التدخل التصحيحي”. ويكتب قائلاً: “في قلب هذه المعضلة الأوسع، يكمن رئيس الوزراء آبي أحمد، وهو قائد معروف بفهمه الشامل للسياسة الإثيوبية”. و”بالنسبة لرجلٍ تدخَّل مرارًا لتهدئة أزمات أكثر تعقيدًا في أقاليم تيجراي وأمهرة وأوروميا، فإن انفصاله وصمته عن سوء الإدارة السياسية في إقليم الصومال يمكن أن يُفسَّر بطريقتين؛ فهو إما أن يكون تسامحًا مدروسًا أو أنه بمثابة نقطة ضعف خطيرة”.
ويؤكد الكاتب أنه على الرغم من أن “السياسة ليست مكانًا للكمال والمثالية، لكنها في ذات الوقت لا يمكن أن تُعدّ ساحةً للجنون”. ولذا يُحذّر الكاتب من أن “حزب الازدهار، على الرغم من عيوبه الهيكلية، لا يمكنه قبول قادة يُشعلون الحرائق ثم يلعبون دور رجال الإطفاء”.
إثيوبيا دولة إفريقية حبيسة.. تستعد لبناء منشأة بحرية بدعم روسي
تستعد إثيوبيا لاستكمال بناء مقرّها البحري الجديد في العاصمة أديس أبابا، مما يُمثّل خطوة في سبيل طموحاتها لإعادة تأسيس قوة بحرية وطنية، على الرغم من كونها دولة حبيسة وغير ساحلية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويضمّ الموقع، الذي تبلغ مساحته 3 هكتارات، مجمعًا من أربعة طوابق يضم مكاتب إدارية وعيادة طبية وقاعات اجتماعات ومرافق رياضية وبنية تحتية داعمة أخرى، ويسير المشروع على الطريق الصحيح للانتهاء في الموعد المحدد. ويُعدّ هذا التطوير جزءًا من إستراتيجية إثيوبيا الأوسع نطاقًا لإعادة تأكيد مكانتها كقوة إقليمية في منطقة القرن الإفريقي.
وعلى الرغم من أن إثيوبيا صارت دولة غير ساحلية منذ استقلال إريتريا عام 1993م، إلا أن السلطات الإثيوبية تُؤكد أن القدرات البحرية ضرورية لحماية طرق التجارة، والاستجابة للتهديدات البحرية العالمية، وضمان الوصول إلى المياه الدولية عبر موانئ الحلفاء في جيبوتي والسودان.
وكانت إثيوبيا قد وقَّعت في مارس 2025 اتفاقية تعاون مع الحكومة الروسية لدعم التطوير والتدريب البحري. ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب انهيار شراكة بحرية سابقة مع فرنسا، والتي بدأت في عام 2018م بعد أن أعلن رئيس الوزراء “آبي أحمد” عن خطط لإحياء القوات البحرية للبلاد.
وقد تم الاتفاق على الشراكة الروسية الإثيوبية خلال زيارة رفيعة المستوى لنائب القائد العام الروسي الأدميرال فلاديمير فوروبييف إلى منشآت بحرية إثيوبية ومركز تدريب في مدينة بيشوفتو؛ حيث تعهد بدعم موسكو لتدريب وتأهيل الأفراد وتعزيز القدرات البحرية الإثيوبية.
ويأتي هذا التطور في ظل تنامي المشاركة العسكرية الروسية في جميع أنحاء إفريقيا. فإلى جانب إثيوبيا، تعمل موسكو على توسيع وجودها في دول مثل مالي؛ حيث تُوفّر مركبات مدرعة ثقيلة، وتبني، بحسب التقارير، بنية تحتية عسكرية.