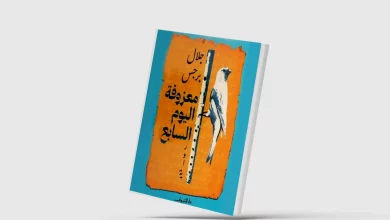عن الكتابة والناس: يقول كارلوس زافون عن تأثير الكتابة”.. أصداء الكلمات التي نظن أننا نسيناها تظل مرافقة لنا طوال الحياة، وتشيد في ذاكرتنا منزلاً نعود إليه عاجلاً أم آجلاً”. فهو يؤمن بقدرة الكتابة على خلق الوعي، تشكيل الذاكرة، صياغة الوجدن، بل وبعث الحياة من جديد!.
صحيح أن رباعيته الشهيرة مقبرة الكتب المنسية، ومن العتبة الأولى تُبرز عنصري الفناء، (الإقبار والنسيان)!، ألا انها – في جوهرها – تتحدى الموت، وتحاول التعبير عن الحياة بكل ما فيها؛ فالكتابة بالنسبة له، هي الحياة. وهذا ما قصده حين قال: “أكتب، وأكتب، وأكتب.. ثم أُعيد الكتابة حتى الموت!”. وقد وفّى بذلك حقّ الوفاء، إذ ظلّ مخلصًا للكتابة حتى آخر أيامه.
اما الكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز فقد حكى في كلمته بمؤتمر الكُتّاب – كاراكاس- فنزويلا 1970م، قصته مع إدوارد بوردا، محرّر الملحق الثقافي لجريدة (إل إسبكتادور)¹، حين كان في بداياته. كان محبطًا من رفض كتاباته الأولى، فذلك الزمن اتسم بصرامة شديدة في ما يلي النشر في الصحف، الملاحق الثقافية ودور النشر، وكان يُنظر للكتابة الرديئة كنوع من الإساءة. فسأل ماركيز بيأس:
“ما السبيل لتجنب الإساءة إليكم يا سيدي؟”
فردّ بوردا بجملة مقتضبة ومفعمة بالمعنى:
“استمر في الكتابة.”
وقد كان هذه الإجابة شرارة البدء لرحلة إبداعية لا تُنسى، حقق خلالها “غابو” فتوحات عظيمة عبر الحكي (الكتابة)، فصاغ بذلك وجدان الشعب الكولومبي، بل وشعوب أمريكا اللاتينية، بما لم تستطعه الثورات.
تقريب المسافات
على مدار ستة وسبعين عامًا – منذ مؤتمر جوبا – بل قبل ذلك، ظلت المسافة الوجدانية بين أقوام السودان متباعدة جدًا، رغم عديد المشتركات التي تجمع هذه الأشتات من الناس، وقد فشلت النخب الحاكمة منذ الإستقلال في تسخير هذه المشتركات لبناء هوية جامعة – كما سماها الدكتور جون قرنق بـ”السودانوية” – أو على الأقل ابتكار طرائق فعّالة لإدارة هذا التنوع الخلّاق. ويظهر هذا الفشل بوضوح في ميداني الإدارة السياسية والسياسة التنموية. على مستوي التنظير والتطبيق!. استثناءً لذلك، كان “مشروع السودان الجديد”. نظرية شاملة تنطلق من جعل التنوع المرتكز الأساسي في بناء الدولة. بدورهم، لم يكن المثقفون وصنّاع الرأي العام بمنأى عن هذا الفشل، إذ لم يتمكنوا – باستثناء مدرسة الغابة والصحراء – من طرح مشروع ثقافي قادر على التأسيس لوحدة وجدانية وفكرية تجمع ولا تفرّق.
في جنوب السودان، لم يكن الأمر أفضل حالاً، فباستثناء ومضات متفرقة، مثل تمرد توريت (1955م)، الأنيانيا ون (1963م–1972م) والحركة الشعبية لتحرير السودان (1983م–2005م)، لم يظهر إجماع لحظي ناهيك عن مشروع قومي جامع يوحد الناس، لا على المستوى السياسي ولا الثقافي. وبدلاً من ذلك، ساهمت السياسات الخاطئة في تعميق الهوة بين المجتمعات، فظهرت هشاشة “وحدة الجنوبيين” التى برزت في فترة اتفاقية أديس أبابا (1972م)، حيث لم تصمد أمام صراعات النخب العبثية، فإنتهت بالتقسيم (كوكورا)¹، وهو حدث مفصلي لم يُدرس بعد بموضوعية تُفضي إلى العبر والدروس.
ثم تكرر الأمر بشكل آخر، تمظهر في انشقاق الناصر عام 1991م، في ظل ظروف حرجة، (فترة النضال ضد حكومة الجبهة القومية الإسلامية “الإنقاذ”)!. قبل ان تبلغ الأمور ذروتها في عام 2013م ثم 2016م، حين أدت الأطماع السلطوية إلى إستخدام القبائل كأدوات في الحرب. وكنتيجة طبيعية لذلك أصبحت المسافة بين المجتمعات شاسعة إلى حد يصعب معه صياغة سياسات إدارية أو ثقافية تقرّب الناس من بعضهم البعض!.
إذاً، ما الحل؟.
الحل في رفع الوعي المجتمعي وهنا يأتي دور الثقافة والفنون، وعلى رأسها الكتابة.. الكتابة الهادفة، التي لا تكتفي بوصف الواقع، بل تحاول تغييره .. كتابة تسعى إلى تقريب المسافات بين الناس، وصياغة وجدانهم، ومخاطبة مخاوفهم، وتفكيك الصور النمطية المتبادلة، وترسيخ ثقافة قبول الآخر، والاحتفاء بالتنوّع.
▪︎ صياغة الوجدان
حين نتحدث عن “صياغة الوجدان”، فإننا لا نقصد به فقط إستثارة العاطفة أو توجيه الإنفعالات الآنية نحو القضايا العامة أو الخاصة، بل نعني به عملية عميقة ومتواصلة لإعادة تشكيل إحساس الناس تجاه أنفسهم، والآخر، والمكان، والتاريخ، والمستقبل. الوجدان، ببساطة، هو تفاعل الإنسان مع العالم من حوله من خلال شعوره العميق بالمعنى. وقد يكون هذا التفاعل عاطفيًا، أو جماليًا، أو أخلاقيًا. لكنّه دائمًا مرتبط بالقيم الكبرى: العدالة، الحرية، الانتماء، الكرامة، والحق في الاختلاف. لذلك، فصياغة الوجدان لا تكون بالشعارات اللحظية، بل بالتراكم الذي يرسّخ تلك القيم في لاوعي الجماعة.
وفي هذا لكل فرد من افراد المجتمع سلطة أخلاقية ومعنوية، منفصلة تمامًا عن السلطات الرسمية في الإصلاح، تبدأ من ذاته. وكلما كان الإنسان متعلمًا (لا أقول مثقفًا، لحساسية المصطلح)، تضاعفت مسؤوليته ومساهمته في صياغة الوجدان الجمعي والبناء الوطني، لا سيّما في جانبه الثقافي والاجتماعي، مستخدمًا ما تتيحه له أدواته، ومنها الكتابة. وهنا تظهر أهمية الأدب والفنون والخطابات الرمزية؛ لأن الإنسان لا يُقاد بالعقل وحده، بل بالمخيال الجمعي، بالمثال، بالرمز، بالقصة. الكتابة إذًا، حين تكون موجّهة بعناية وصدق، تصبح فعل تشكيل وجداني، تبني في الناس إحساسًا أرقى بالذات والآخر، وتُعيد تعريف العلاقات المتوترة داخل المجتمع على أساس جديد قوامه التفاهم لا التنافر، والقبول لا الإقصاء.
أن الكتابة الموجّهة هي الأداة الأعمق أثرًا، إذ أنها تتيح التراكم والعودة، والتأمل في النصوص بعيدًا عن صخب اللحظة. ومن خلال هذا التراكم والعودة التأملية، يتسرّب الخطاب الموجّه إلى القلوب، فيلمس موطن الغرائز الفطرية التي قسمها إدموند هولمز إلى ستة غرائز. أهمها ما أسماه بالغريزة الإنسانية، وهي الرغبة في التفاعل مع الآخر، العيش المشترك وصنع أشياء جميلة.
هذه الرغبة، أو القوة الداخلية التي تدفع المرء للشعور والتفاعل مع العالم من حوله، هي ما يُعرف بالوجدان، لذلك، فإن مسؤولية كل من يمتلك الكلمة، أو القدرة على التأثير – سواء كان كاتبًا، أو معلمًا، أو فنانًا، أو ناشطًا مجتمعيًا – هي مسؤولية وجدانية، أخلاقية بالأساس. لأن ما يُقال ويُكتب ويُمثَّل ويُغنّى ويُدرّس، كلّه يدخل في نسيج الوجدان، فيحدد شكل المجتمع الذي نعيش فيه: هل هو مجتمع تسامح وتعدد، أم مجتمع رفض وتناحر؟.
ففي النهاية، ليست صياغة الوجدان ترفًا ثقافيًا أو خطابًا نخبويًا، بل هي شرط أساسي لبناء مجتمع قابل للحياة، لأن الشعور الجمعي هو أساس الفعل الجمعي، والفعل الجمعي هو الذي يصنع التاريخ. والتاريخ بدوره يصنع الجغرافيا كما يقول المؤرخ البريطاني “أرنولد ج. توينبي”
ختاماً ..
ان الكتابة ليست رفاهًا، بل فعل مقاومة.
وهي ليست فقط دواء لتسكين الألم أو وسيلة للتشافي، بل معول لترميم، وتركيب الأمل في زمن التشظي.
الحضور الجميل ..
نكتب لا لأننا نعرف، بل لأننا نؤمن بأن الكلمة قد تُضيء عتمة، أو تقرّب قلبًا، أو تُعيد ما إنقطع من وِصال.
نكتب .. لنعيد للناس إيمانهم ببعضهم، ولنجعل من التنوع نعمة لا نقمة.
نكتب.. من أجل تقريب المسافات، التي تُقاس بالحب والإحترام، لا بالاميال والخرائط.
نكتب .. من أجل وطنٍ يشبه أحلامنا. وطنٍ لا يُقتل فيه أحدًا، بل لا يُقصي فيه أحدًا.
شكراً لتكبدكم عناء الجلوس لساعات طوال من أجل مشاركتنا هذه الأمسية التي لو لا حضوركم لما اصبحت لطيفة بهذا الشكل.
▪︎ هوامش:
إل إسبكتادور (El Espectador): صحيفة كولومبية تأسست عام 1887، تُعرف بمواقفها التحريرية المستقلة.
كوكورا: كلمة بلغة الباريا/باري، تعني “القسمة” أو “التقسيم”.
_
* جزء من مؤانسة ثقافية عن الكتابة بعنوان:
الكتابة والناس .. ”تقريب المسافات وصياغة الوجدان”. قُدمت بمركز سينياس هاب – ابريل 2023م
* كاتب روائي جنوب سوداني